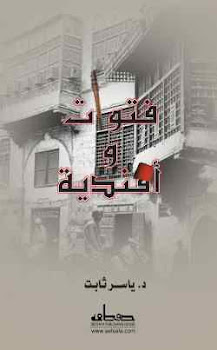كتاب الرغبة (10): حبة الفراولة

وعبر 101 صفحة نعيش مأساة سارة، تلك التي انهارت بتواطؤ مريبٍ من الجميع، ممن خنقوا إنسانيتها وتركوها ضائعة، لا تعرف أي الدروب تسلك: التشدد أم المجون!
بطلة الرواية هنا تتذكر، والذي يعود إلى ذكرياتٍ قاسية كالذي يلقي بنفسه مرةً ثانية تحت عجلات قطار ليعيد دهسه مرةً أخرى. ولكن، كيف لك أن تتحاشى عجلات قطارٍ مندفع وكل ما حولك قضبان؟!
إنها تدين مجتمعها والقيود التي كبلتها كإنسانة، وتفضح رموزاً مضللة، لندرك معها أن مرتكبي جرائم التشويه لا يمكن أبداً أن يصبحوا خبراء في التجميل
أول الرواية غضب
إنها تحاسب الجميع، وتدينهم بارتكاب سلسلة من الجرائم بحقها.. والضحية عيناها دوماً ضريرتان عن رؤية شيء أبعد من الجريمة التي وقعت لها، والأذى حذاءٌ عسكري ثقيل يهوي كمطرقةٍ على صدرها وذاكرتها
تحكي سارة عن الزوج الأول عبد الله فتقول: "أما أنتَ فستضحكُ الملائكةُ منكَ حتى تستلقي على أجنحتها الفارهة
لأنك ثورٌ زوجوك وطلقوك" (ص 6)
وفي موضعٍ آخر تخاطبه قائلة: "أعلمه أن الحياة مضت بك بين السجود لعظمته واعتلاء البقرة الولود
بين الملذاتِ العلوية في حضرته والسفلية في حضرة ساقيها المنفرجتين، ثم ما ازددت إلا خبالاً
لكني أعرف جُبنكَ، ستولي هارباً من ربك وترمي بجثتك الضخمة فوقي" (ص 6)
وهي لا تتوقف عنده، إذ تحمل على أخته فلوة التي تصفها لأول مرة في الرواية بالقول: "وأختك الخشبة المسندة متّشحةٌ بالسواد إلى قدميها، تبسمل وتحوقل، بينما تجرني على بطني في وادي الزناة ثم تلقى بي في ركنٍ قصي مظلم" (ص 6). وما بين فترةٍ وأخرى، تقفز هذه المرأة إلى ذاكرتها فتصب عليها جام لعناتها، ومن ذلك قولها في مناجاةٍ مع النفس: "أما فلوة فتستحق المرور بجهنم بضعة أيامٍ حتى تستوي مؤخرتها ويتحجَر برازها الأسود في أمعائها فلا تعبث مع بنات الآخرة عبثها معي" (ص 37)
وفي منتصف الرواية تخبرنا الساردة عن مصير فلوة وأخيها: "عبد الله اختفى مثل فقاعةٍ ذابت في الكون وقد تركته أختُه لتتدارك شيئاً من نعيم الثعبان مع مطوع اعتزل الناس في القصيم بين زرعه ونخيله" (ص 48)
وأثناء رحلة استجمامٍ لها مع أخيها عمر إلى شرم الشيخ، يدور بينهما الحوار التالي:
" – هل تعرف حينما أسترجع حياتي، لا أحد ولا شيء يؤلمني مثل فلوة
- كيف؟
- هي من نهشَ لحمي وسلبني كل إرادةٍ لا هُم
ترددتُ قليلاً قبل أن أكمل بلا خجل:
- لقد أعدّت الحفلة حتى يمتطيني الرجال. وكانت العانس تتلمظ بمتعةٍ مكبوتة وهما يتناوبان عليّ. هل تتخيل هذا الشعور الغريب؟ إنها عمليةٌ تشبه القوادة
ابتسم عمر بعصبيّة:
- لكنّها قوادة شرعية يا سارة!" (ص 31)
إنها تشعر بالظلم الذي وقع عليها، حين عاشت أو عانت "في فراش عبد الله، ثم في فراش القصير السمين. ومن قبل الشبق ومن بعده في لّجة الوساوس السوداء التي ستقتاتُ بشراهةٍ بدمي وأعصابي" (ص 13). كما أنها تحزن للطريق الطويل الذي مشته من دون أن تتوقف لحظة "لكيلا أشعر بروحي التي شاخت
أو أبكي جسدي الذي قدّمته عشيّةً بعد عشيّةٍ قر باناً على مذبح شهواتهم الحلال
لكيلا أستشعر فصامهم الذي شطر ذاتي نصفين. ودجلهم الذي تعاونوا رجالاً ونساءً على حقنه في تلافيف دماغي يوماً بعد يوم" (ص 8- 9)
ثم تنتقم بسلاح الخيال الساخر من الجميع: الزوج الأول وأخته، والزوج الثاني، والداعية الشهيرة في مدينة الرياض
"أنف فلوة في مؤخرة علي، ولسان عبد الله الخشن يجوس بين فخذي فاطمة" (ص 7)
وحين تصف الزوج الثاني "السمين القصير، القصير الدميم، القادم على ظهر بغلته" (ص 5) فإنها تلجأ إلى ألفاظٍ وعبارات في التراث تشير إلى الفعل الجنسي للحديث عن رغباته الجسدية: "قل له إن الدميم في دمه هوى القعود بين شعبها الأربع والعفس الشديد والجمع بين الركبة والوريد، فليخصص له من الحور العين سبعين يلقاهن دحماً دحماً ويعدن في كل مرةٍ أبكاراً" (ص 5)
علاقة شائكةٌ وشبه غامضةٍ تربطها بالأم التي تصفها قائلةً: "أمي في غيها فلا تثريب عليها" (ص 15)، وفي مناجاةٍ مع النفس تقول: "لو أنك يا الله أخذت أمي وتركت لي أبي، ماذا كان سيخرب على ظهر هذه البسيطة؟
لا شيء البتة!
ماذا كان سينقص أو يزيد؟
ولا حبّة خردل
تلك المرأة منذ جهلت وخلقتَها وهي والهامش سواء بسواء
دوماً كانت أقصى من نجمةٍ قصيّة، فلن يليق بمقامها سوى عليائك، سوى أن تغسل رجليك وتدلك ظهرك بالزيوت العطريّة ثم ترقد على سنامك" (ص 36-37)
وعندما يسافر أخوها عمر من دون أن يودعها، تنفجر في وجه أمها: "صرختُ في وجه الكائن المقيت:
- هل أنتِ أمّ؟ هل خرجتُ من رحمكِ؟ لِمَ لم تحضيه على زيارتي وتوديعي؟!
كأنها لا تسمعني" (ص 38)
وهي ترسم صورة عدم مبالاة الأم بها حتى في الآخرة، فتقول: "تنظر إلى التنور فتراني نخلةً والنار تضطرم في رأسي. لا تعبأ كعادتها وتستدير بصفاقةٍ لتقع على بطنها فوق عشرةٍ من غلمان مخصيين لا يشفون لها غليلاً
تأوهاتٌ وأصواتٌ وقُبلٌ فاقعة" (ص 7)
وفي مقابل الأم، تبدو لنا الجدة صايلة أكثر حباً وحناناً، كأنها الأم البديلة
وبعد سماع دفاعها ودفوعها، تبحر بنا سارة في الذاكرة، فنراها طالبةً في المدرسة الثانوية في سلطانة – أحد أحياء
 غرب الرياض- وقد ضبطتها الاختصاصيةُ الاجتماعية فلوة بالجُرم المشهود: إخفاء روايتين من روايات "عبير" في دُرجها بالفصل. تلومها فلوة على فعلتها، وتعاقبها مديرة المدرسة، قبل أن تعود الاختصاصية الاجتماعية لتهديء من روعها وتبلغها بأن إدارة المدرسة لن تكلم أهلها، وأنها ستتوسط لها عند المديرة حتى تكتفي بالتعهد الذي كتبته. هنا تحكي الساردة: "وقعتُ على يدها اليمنى أقبّلها بامتنانٍ طفولي
غرب الرياض- وقد ضبطتها الاختصاصيةُ الاجتماعية فلوة بالجُرم المشهود: إخفاء روايتين من روايات "عبير" في دُرجها بالفصل. تلومها فلوة على فعلتها، وتعاقبها مديرة المدرسة، قبل أن تعود الاختصاصية الاجتماعية لتهديء من روعها وتبلغها بأن إدارة المدرسة لن تكلم أهلها، وأنها ستتوسط لها عند المديرة حتى تكتفي بالتعهد الذي كتبته. هنا تحكي الساردة: "وقعتُ على يدها اليمنى أقبّلها بامتنانٍ طفوليالمرة الأولى في حياتي التي أنحني فيها على يد
لا أدري ماذا كان شعورها، أو بماذا فكرت في تلك اللحظات، لكنني الآن أعي أن ذلك كان إيذاناً ببدء تاريخ عبوديتي
ذلك التاريخ السحيق الذي سلب من إنسانيتي حسها ومن روحي رفيفها العلوي، وأطلق العجلة لتدور بسرعةٍ خرافية فوق كل خليةٍ من خلايا جسدي وذاكرتي، ولتشكّل تلك المرأة بيديها القاسيتين مصيري، بلا وجلٍ، وبلا تردد وبلا رحمة، وبلا شعورٍ بالذنب" (ص 12)
منذ ذلك اليوم، أصبحت سارة تدور في فلك الاختصاصية الاجتماعية فلوة، التي أغرقتها بالكتيبات وأشرطة الكاسيت الدينية لمشاهير شيوخ الصحوة، التي صارت الفتاة تخصص لها وقتاً يفوق ما تخصصه لدروسها . وتحت تأثير وسطوة فلوة، تحرق سارة كل ما تملكه من صورٍ وقصص ومجلات وتذكارات ودُمى وأشرطة أغانٍ، حتى تؤكد قدرتها على هزيمة النفس والشيطان
وفي آخر يومٍ من الامتحان النهائي، تباغتها فلوة بلا تمهيد بالقول إنها لن تجد أفضل منها زوجة لأخيها عبد الله. المواصفات تبدو مطابقة، إذ تصف سارة نفسها آنذاك بأنها "مطوعة صغيرة جديدة، وقبيلية مثلها، وجميلة ومهذبة..ونعجة صغيرة!" (ص 15)
تقول لها فلوة إن أخاها يمضي حياته من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد، لكن سارة تسخر قائلةً: "وسأعرف بعد ذلك أنه من البيت لعليشة ومن عليشة للبيت" (ص 16)، في إشارةٍ إلى الموقع السابق لمستشفى المصحة النفسية بحي عليشة في الرياض
تتحدى سارة أخاها عمر وتتجاهل نصيحته لها برفض هذا الرجل غريب الأطوار الذي يكبرها بخمسة عشر عاماً، ليتم الزواج وتنتقل الريشة الخفيفة التي تذروها الرياح إلى منزل الزوجية، وهو طابق أرضي في فيلا قديمة بحي الشفاء قرب الرياض
 هناك تجد نفسها أمام لحظةٍ عصية على النسيان وعلى التأويل: البعض يتوهم أن ليلة الوصال تعني أن تغادر رأسك إلى حفلة الجسد.. أن تخرج قلبك من المعادلة وتقطف العابرة من براءتها إلى السرير
هناك تجد نفسها أمام لحظةٍ عصية على النسيان وعلى التأويل: البعض يتوهم أن ليلة الوصال تعني أن تغادر رأسك إلى حفلة الجسد.. أن تخرج قلبك من المعادلة وتقطف العابرة من براءتها إلى السرير"خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً إلى الصُفرة يصل إلى حدود ركبتيه
لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. ولم أر شوكولاتة ولا فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا همسة. ولم يداعبني، ولم يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو تتخيل
لكنه برك. هكذا برك كما يبرك البعير الأجرب، وبدأ يمطرني بقُبلٍ متلاحقة مجنونة على وجهي. يأكل فمي، ويمضغ لساني، ويحك أسنانه بأسناني، وأصابعه تعتصر تفّاحتَي بشدة حتى يبلغ الوجع العبقري رقبتي
لم يتركني إلا مع أذان الفجر
إذن هكذا يرحم الله البنات في لياليهن الأولى. يؤذن المؤذن فتُطوى الثعابين السامة ويضممن أرجلهن
أعطيته ظهري دقائق والصداع يكاد يقسم رأسي نصفين. أشعر بالغثيان، وبأن معدتي الفارغة ستلفظ بطانتها قبل ضوء الصباح
قمتُ متثاقلةً إلى الحمام، أسحب رجلي سحباً. الألم بين فخذي لا يُحتمل وكأن أفعى ضخمة، كأن حيواناً برياً قد دخل في أحشائي، ومَزق لحمي، ولم يخرج
رأيته يتفقد السرير والأغطية ووجهه منشرح
لحقتني إلى أرضيةِ الحمام بضعُ قطراتٍ من الدم المائل إلى السواد. اغتسلتُ وكتمت الأنين والماء يلامس جرحي الطري" (ص 19-20)
غير أن الزلزال يقع قرب الساعة الثالثة من صباح أحد الأيام
تستيقظ سارة على صوت أنينٍ مكتوم، لتجد عبد الله ساجداً على الأرض وهو ينشج. وعندما تقترب منه يصرخ بها طالباً منها الابتعاد، قبل أن يقترب منها ويعانقها بطريقته الفظة. "رفع يده إلى الأعلى وبدأ يسب الله بكلماتٍ جنسية ساقطة. لم أصدق نفسي. رأيتُ قبائل من الجن تحوم حولنا في هرجٍ ومرج" (ص25)
وفي الصباح تهاتف فلوة لتخبرها بما جرى، لتكتشف تدريجياً أن عبد الله مريض نفسياً. وتناولها فلوة مظروفاً صغيراً قبل أن تقول لها من دون أن تكلف نفسها عناء التفسير أو حتى طمأنتها: "- اسمعي، سأذهب إلى المدرسة، أما أنتِ فاتركيه حتى يستيقظ وحده. في هذا المظروف بطاقة المستشفى وتقريره الطبي. جهزي له سجادةً وملابس ربّما أدخلوه! سأمر بك بعد الظهر لنرى!" (ص 28)
وقعُ الصدمة كان قوياً على بطلة الرواية
أسئلةٌ وعلامات استفهام تصيبها بالدوار إذ تقول لنفسها: "من ظل يضاجعني إذاً كل ليلةٍ عاماً وشهرين كان "ممن أدخلوهم"!
لا اعتراض لي على دخوله المستشفى والخروج منه، ولا على دخول قضيبه أحشائي وخروجه، لكن لِمَ لم أعلم قبل اليوم؟
الجدران العارية ستتوقف لحظةً عن القهقهة، وتجيبني:
هذه مشكلة النعاج!" (ص 28)
تجلسُ على طرف السرير تتأمل بصمتٍ الزوج النائم وهو في غيبوبةٍ أو في نصف ميتة، وتتساءل: "تراه يحلم؟ أم يتألم ويتوجع؟ أم يحادث ربه ويجادله؟ أم يفكر؟
حسناً فيمَ يفكر؟ في ثعابين القبر، أم في ثعبانه هو، أم في الوادي الضيق بين فخذيّ، أم في مؤخرتي التي يتمناها ويحرّمها، أم في الطهارة؟ أم في الملائكة؟ أم في الخلق؟ أم في شوايةٍ عليها تسعة عشر؟ أم في غلمانٍ كالدر المنثور؟" (ص 29)
بعد مرض عبد الله، تتعذب سارة نفسياً وتشعر بالضيق والحرمان الجسدي. وحين ترى من خلف الستارة خالد ابن أخت الجدة الذي اعتاد زيارتها بانتظام، تُعجبُ بهذا الشاب وتحترق بنار الرغبة
"لم أستعذ بالله ولم أتراجع ولم أغضّ بصري
بل كنتُ ملتذةً بالتلصص
غريزةٌ همجية اضطرمت في داخلي كالجمر وأنا أحدق في الشاب بقامته الطويلة وابتسامته الحلوة وثيابه النظيفة
تذكرتُ أبطال الروايات التي أحرقتُها في معبد فلوة
ثم شعرتُ ب(رطوبة) هناك. برطوبةٍ في الوادي المقدس. شعرتُ برطوبةٍ ونبض أو بنبضٍ ورطوبة. استطالت حبة
 الفراولة الصغيرة واشتعلت. أحلمُ بفم هذا الشاب الناعم يُقبلُها، ويمصُها ويرشفها. أضغطُ فخذاً بفخذ، فتزداد السخونة
الفراولة الصغيرة واشتعلت. أحلمُ بفم هذا الشاب الناعم يُقبلُها، ويمصُها ويرشفها. أضغطُ فخذاً بفخذ، فتزداد السخونة
يا رب إن لم تسرع بشفائي فعجل بجنوني
فتحتُ الباب على عبد الله. المرض قد نخله، فبقي سلبياً شبه مستسلم وترك الأمر لي. قمتُ فوقه بتوقٍ وشوق وهو راقد على ظهره. أنشبُ أظفاري في لحم رقبته قائمة قاعدة. قاعدةً قائمة. أغمضُ عيني عن المريض الأشعث، لأضاجع ذاك الناعم النظيف البعيد
أكبرُ لصلاتي فيحجب وجهه عني وجه الله، وإذا ركعتُ وجدته أكبر من الله، وإذا سجدتُ صار أقرب لي من الله
تتسارعُ أنفاسي وأنا على تخومِ اللذة القصوى
أنشبُ أظفاري أكثر. وأشتعلُ كنمرةٍ جائعة
وفي لحظة، لحظة لا تُقال ولا تُوصف ولا تُحكى ولا تُعاد، أتوقف عن القيام والقعود فوقه لأن الجنة ستداعب أقدامي. بدأت الجنةُ تغمرني هكذا، فأسقط على ظهري ثملةً من اللذة لأتوسد ساقيه الممدوتين
إحساسٌ جديد أمطرت معه خزائن السماء ورداً وياسميناً
ولربع ساعةٍ توّجتُ ملكةً على البر والماء" (ص 39-40)
البطلة هنا تبدو وحيدةً كهرةٍ جائعة تموء وسط مقبرة
هذه التجربة ستمر بها في مناسبةٍ أخرى، حين تذهب بسيارة الشاب خالد مع الجدة صايلة إلى مستشفى، للقاء اختصاصية سعودية تنقذها من أزمتها النفسية وتلك الوساوس القهرية
"أعبث بالقفاز الأسود، أمطُه فتخرج أصابعي منه ثم أعيد إدخالها ثانيةً، إن نظرتُ أمامي وقعت عيني على يد الشاب البيضاء تمسك بالمقود فأصرفها مسرعةً
أستعيذ بالله في سرّي بينما أستعيد طيفاً بعيداً لمضاجعته اللذيذة فوق جثة عبد الله، يوم دخلتُ المغارة المسحورة فأمطرتني شلالات عدن
أشعرُ بخيطٍ من الماء الساخن (هناك) فأتلهى بذكر الله" (ص 76)
وفي أعقاب الطلاق، تزداد الوردةُ ذبولاً والمرأة ذهولاً، فتصحبها الجدة إلى أحد الشيوخ في حي الربوة شرق الرياض، لعله يساعدها على الشفاء من وساوسها وأحزانها. وتحكي البطلة كيف أخذ الشيخ في قراءة القرآن عليها، وهو يخفي شبقه
"اقتربَ مني. ثم اقتربَ أكثر
بسملَ وبدأ يقرأ القرآن ورذاذُ فمه يتطاير نحوي
جدتي تهلّل وتستغفر وهو يقرأ. لا ينشرح صدري ولا ينقبض ويقرأ. يلعب بشعر لحيته ويقرأ
أسمعُ صوت أنفاسه اللاهثة ويقرأ. تطفحُ بي الهواجس ويقرأ. يضعُ كفه على فخذي ويقرأ
يمتلىء رأسي بالأخيلة ويقرأ. أشعرُ بضغط أصابعه على لحمي ويقرأ. تجتاحني رائحة عبد الله ويقرأ. تصعد كفه إلى أعلى فخذي ويقرأ. تجوس أصابعه في الوادي الصغير ويقرأ. تسد الثيران الهائجة باب الحجرة ويقرأ" (ص 43)
وبلمح البصر، أصبح الشيخ القصير السمين زوجها الثاني
وجدت سارة نفسها زوجة لرجلٍ متزوج من "شامية"، إضافةً إلى زوجة عجوز تقيم مع ابنتها في بيت الربوة. وفي لقائهما الأول تتحرك الغيرة: "أما حين رأتني الشامية أول مرة فإن ابتسامة متهكمةً ارتسمت على فمها القرمزي:
- الشيخ شو بدو فيكِ؟
هو أعلمُ بأمور دنياه يا هديب الشام
ربما لم تشبعيه ولا هي، لا أفخاذ بريدة ولا مؤخرة دير الزور الفارهة. لا ثقوبك الضيقة الدافئة ولا ثقوب القصيمية الباردة المترهلة
ربما يُستثارُ أكثر إذا ضاجعني أنا، إذا ضاجع مهلوسةً موسوسةً، مريضةً موجوعة مثلي أنا" (ص 47)
تُفاجأ سارة بقيود وأوامر الشيخ أو الزوج الجديد. قائمة طويلة من الممنوعات، لتصبح حبيسة جدران المنزل

وفي منزل الشيخ، تصدمها مفاجأةٌ جديدة
" هبطتُ الدرج على أطراف أصابعي، ودفعتُ الباب الخشبي بلا جلبة، لأمشي بتصميمٍ غريب نحو غرفتهما في آخر الممر سمعتُ الشامية ترتل القرآن بصوتٍ متقطع، فلم تداخلني أية سكينة أو طمأنينة: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون". تسارع دقّ قلبي وانا أضع عيني في ثقب الباب وأنظر: "فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون"
علقتُ من شعر رأسي ودارت بي الأرضُ مئة دورةٍ ثم أسقطت في هوةٍ سحيقة
كانت ساجدةً على مصلاها وبغنجٍ قد بلغت قوله: "أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جناتُ المأوى نُزلاً بما كانوا يعملون"، بينما هو خلفها يمسكها من خاصرتها، ويدفع دفعاً شديداً، موغلاً بثعبانه الضخم في مؤخرتها. "وأما الذين فسقوا فمأواهم النار". لم تكمل الآية لأنها بدأت بالتأوه بصوتٍ عالٍ. رأيتُ إبليس بقرنيه الطويلين ورأسه الأصلع يضحك في وجهي فصرخت
فتح الدميم الباب وهو خائفٌ
يرتدي فانيلةً قطنيّة ونصفه الأسفل عارٍ. أما هي فكما سقطت من بطن أمها
أمسكني من جديلتي الطويلة وبدأ كالمجنون يضرب رأسي بالجدار
يبصق عليَ مخاطه اللزج بحقد
هي تسب وتشتم:
- (يئطع هيك أشكال. دخلك هيدي مرا ولاّ شرموطة)؟
والدم يقطر من سقف فمي ساخناً، وأصابعه تقتلع منابت شعري
دفعني بقدمه فوقعت أرضاً ليبدأ بركلي بعنفٍ صارخاً بأعلى صوته:
- (يا ساقطة، أنت ساقطة وبس، الشرهه على من يتزوج ساقطة مجنونة)
تصاعد الألم إلى كل شبرٍ من جسدي، لكن...
قولي للخبيث أنا لست شامية!
قولي للشيخ أنا لا أسجد!
ساقوني إلى غرفتي كومة لحم. تمددت على سريري، وامتلأ الوجود بآلاف العاريات البيض الساجدات لربهن
تأوهٌ وأنين، صلاة وقرآن، دفع ودفق، والملائكة تنظر إلى فنون النكاح بشبقٍ ووله
نبت الشيطان بين عيني، ولمَ لا أكون شامية؟ إن حور الجنة شاميات قصيرات القامة يركعن ويسجدن ويحملن ويطوين" (ص 50-52)

وبين يدي الاختصاصية السعودية، تفتح سارة خزائن مشاعرها وانكساراتها، وتحكي لها في إحدى الجلسات عن تلصصها على القصير السمين مع الشامية وتأثير ذلك على جسدها وشهوتها
"تعرفين ماذا يحدث حين أغتسل سبع مراتٍ متتاليات بالماء والصابون والسدر ويظل هاجسي هو القذارة التي تنبتُ من حبّة الفراولة بين فخذي حتى تصل إلى آخر شعرةٍ في رأسي
ستعبثُ إصبعي بالفراولة وبين ناظري الثعبان الذي يقرصُ مؤخرة الشامية
وستدعكُ إصبعي حبّة الفراولة وتعصرها وبين عيني شرج الشامية وعضو الشيخ علي
أو عضو الشيخ علي داخل شرج الشامية. ثم سأشم رائحة القرنفل ويعلو صياحي من اللذة" (ص 80)
وتنساب الأسرار مثل جدولٍ صغير
"أوشكتْ أن تحرّك شفتيها لتقول شيئاً ولكنني أردفتُ:
- لم أكن أعلم حينذاك أن للدنيا مسرّاتها حتى اكتشفت إصبعي طريقها إلى حبّة الفراولة
- لقد كنتُ أتحاملُ على نفسي لأمنح الشيخ علي حقه حتى لو كانت الإنفلونزا تدقُ عظمي
ألفُ طرحةً قطنية رخيصةً على أنفي وفمي حتى لا يمرض الدميمُ القصير ثم أتركه ينتهك اللحم بطناً على بطن أو بطناً على ظهر
إذا خلص من قذارته ذهبت إلى البانيو لأدعك حبّة الفراولة وأبكي من اللذة التي لم أعرفها تحت علي ولا فوقه، ولا فوق عبد الله ولا تحته" (ص 83)
وبمساعدة الأخ، تلتقي سارة فارسها: مشاري
أختي سارة مطوعة تائبة!"
ابتسم وانحنى على يدي يقبّلها:
- من يتخيل أن المطوعات بهذا الجمال!
أظنني اشتعلتُ مثل عود ثقاب" (ص 44)
وهي تقع في هواه منذ اللحظة الأولى، أو منذ اللقاء الأول في تلك السهرة الخاصة والمستترة في الرياض. "كنتُ أرتدي فستاناً فستقياً بلا كُمَين. أجلسني من كتفي مثل طفلةٍ بلهاء وجلس أمامي
أشعلت أصابعه الحريق في كتفي فهو أكثر فتنةً مما أتصور أو أتخيّل لرجل
أعجبُ بهذا المجنون أم أعيب عليه. جريء أكثر مما ينبغي لرجلٍ مع امرأة. لكنه مهذّب، أو هو مهذّب حتى الساعة
عبد الله أيضاً ظل مهذباً إلى حين.. إلى حين أن برك كبعير. أما القصير السمين فلا يُقاسُ عليه" (ص 46)
وما بين المطاعم ذات الستائر في الرياض، ولندن ذات الحدائق، تنمو الحكاية، بعلم الأخ المتحرر عمر. وربما يتعين هنا أن نشير إلى تكرار الروائيات السعوديات – رجاء الصانع، زينب حفني، سارة العليوي..إلخ- ذكر لندن بشوارعها وأحيائها ومطاعمها، كأنها مدينة الخلاص ورمز التحرر من قيود الحياة في السعودية. ففي حديقة بلومسبري سكوير، تقول سارة لمشاري: "- ليت الله خلقني عشبةً أو ورقةً خضراء في هذه الحديقة!
قال بلؤم وأصابعه تقرص خاصرتي:
- آآآه تفضلين أن تكوني نبتةً إنجليزية على أن تكوني امرأة سعودية؟!
- بل أفضلُ الجمادات على أن أكون مطوعة!" (ص 68)
غير أن زوجة مشاري – هدى- تظل حاجزاً بين الاثنين، ويبرر لها مشاري موقفه بأنه لا يخون زوجته لأنه لم يحبها لحظة واحدة، فترد عليه قائلة:" - لكنها تبقى خيانة
- بغضبٍ مكتوم: خيانة أمام من؟ أمام الله الذي استأثر بالهناء فلا يقاسي ما نقاسيه من عذابٍ ولوعة؟ أمام مجتمعٍ منافق مريض يشذ عن باقي الخلق؟ أمام من قولي؟" (ص 69)
وفي أحد ملاهي لندن أيضاً، تصاب سارة بالجنون فتندفع لتقف في ممر متوسط بين الطاولات. "سكبتُ من النبيذ الأحمر على رأسي ثم نفضته، خلعتُ حذائي وفتحتُ زرّ بلوزتي العلوي والذي يليه، ثم بدأتُ أرقص ببدائية متعمّدة هزّ صدري بعنف" (ص 71)، لتسمع تعليقات ماجنة من ثلاثة شبان عراقيين، قبل أن ينهرها عمر ومشاري، ويقول لها الأخير: "افهمي! التحرر مش مجون ولا عربدة..افهمي يا مجنونة وإلا أفهمتك على طريقتي!" (ص 72)
لكن البعض لا يفهم..أو لا يريد أن يفهم
تزداد حرارة القُبل والملامسات بين العاشقين. وفي أحد الشاليهات المطلة مباشرة على البحر في الخُبر، تقترب سارة من غرفة مشاري، الذي يدعوها إلى الدخول ثم يغازلها فتشتعل كل حرائقُ الكون تحت جلدها، ويجتاحها كإعصارٍ مدمر يربك خارطة جسدها النافر حد الفضيحة المدوية
والجنس نصٌ يكتبه اثنان في لحظةٍ واحدة، كأنهما ساعيا بريد يلتقيان ليسلم كل منهما الآخر طرداً مكتوباً عليه جسداهما
"أجلس على الأرض عند قدميه، تطيش يدي منفلتةً عابثةً في كل اتجاه. أسحب بيجامته للأسفل وهو مستسلمٌ وناعس... أداعب ذلك (الكائن الجميل) بأطراف أصابعي، أقبّله وارشفه حتى أذوق بطرف لساني شيئاً من لزوجته. وبوجلٍ أدفن وجهي في الحديقة البابلية الزكية، فأموتُ ويموت معي ألف ميتةٍ ولا أحييه" (ص 87)
والعاشق كالصوفي، إن كتم وهج حال المقامات المتفجر بداخله مات محتقناً بإشراقاته
الله أكبر! نعناع هذا يا مسلمين أم نبيذ؟" (ص 97)
ومع أنها تزوره في منزله بداعي الحصول على مجموعة كتبٍ من مكتبته، فإن سارة تشعر بظلال الزوجة - المقيمة عند أهلها- فتقرر مغادرة المنزل، لأن جروحها مفتوحة على المدى، وتخبر مشاري وهي تطبع قبلةً أسفل خده بحاجتها إلى وقتٍ طويل للتصالح مع ذاتها والعالم، وإعادة بناء روحها المتشظية
وحين تتناثر الروح على أرض الحياة مثل زجاج مكسور، تزداد شروخ الجسد الذي تمزقه الرغبات
وتبقى ملاحظاتٌ ثلاث نوردها على عجالة. الأولى تتعلق بالأسلوب الروائي المتمكن واللغة المكثفة التي استخدمتها وردة عبد الملك، بل إنها قد تكون قد نظمت الشعر، فاللغة وإيقاعها والصور وتكثيف اللحظة، من أدوات الشعراء التي استخدمتها الروائية ببراعة. وفي حوار أجرته معها جريدة "الأخبار" اللبنانية عبر البريد الإلكتروني، اكتفت وردة عبد الملك بالقول: "إني امرأةٌ سعودية في أوائل الثلاثينيات من عمري. أمضيت حياتي كلها في السعودية. اخترت النشر باسم مستعار مراعاة لأمور عدة، أولها الوضع الاجتماعي في السعودية. لا أحد في اعتقادي يستطيع أن يحتمل وزر رواية كهذه في المكان والزمان اللذين أعيش فيهما"
قل لرّبك الذي تقدس في السماء أن يأخذ الدميم القصير إلى مكانٍ ما تحت عرشه. أو ليلقِ به في زاويةٍ من الجنة. أو في سردابٍ من جهنم. أو لينسه في منزلةٍ بين المنزلتين" (ص 5)
وهي تقول إنه في اليوم الآخر "يكشفُ الله عن ساقه فإذا خلخاله يُحدِثُ شنةً ورنة لكن القوم لاهون" (ص 7)
وفي وقفةٍ مع النفس تتساءل قائلةً: "الساعة أسأل نفسي: ألم يكن لجنتهم العجيبة من بابٍ آخر؟ من نافذةٍ أخرى؟ أو حتى من خرم آخر؟
ما هذا الفردوسُ الوحشي الذي لا ندخله حتى نقتلَ الحياةَ في قلوبنا، وندفن أرواجنا تحت ترابٍ، فوقه تراب؟" (ص 13) وفي سياق الحديث عن جدتها تقول: "مشطت شعري وسقتني اللبن وحدثتني عن ربها الطيب الذي لا يشبه في شيء ربي الكاره الحقود" (ص 39)
وتكر حبات المسبحة: "في ليلةٍ أطول من ألف شهر شعرت كالعادة بضيقٍ شديد، ففررتُ لربي قائمةً ساجدة، لكني كلما اقتربتُ منه زاد في إعراضه، كأنما يلذُ له عذابي" (ص 50) "الأوبة" رواية تصرخ في وجوه الجميع
إنها روايةٌ عن العشق والخديعة والألم، ، تحاسب الجناة، ولسان حال بطلتها يقول: ما عذر جسدي لو انشقت الثياب؟ وما جدوى الثياب إذا ما صرخ الجسد؟