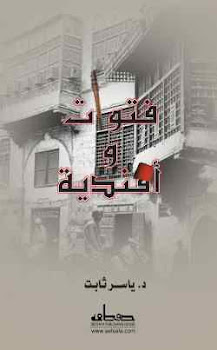عصر الجواري.. والباشوات أيضاً

الرقيق، كانت كلمة السر في مصر لزمن طويل
فقد كانت تجارة الرقيق منتشرة، وخاصة بين مصر والسودان
وفي مذكراته المهمة، يقول السياسي والمؤرخ أحمد شفيق باشا (1860- 1940) "كان الرقيق يكاد يعتبر يومئذ جزءاً من الأسرة. وكانت تجارة الرقيق منتشرة في البلاد، سواء منه الأسود أو الأبيض
"وكانت توجد في القاهرة بيوت خاصة ببيع الرقيق تعرض بواسطة (يسرجيات أو يسرجيين) فكان يرتاد هذه البيوت من يريد اقتناء الجواري أو المماليك أو العبيد
"وكان المعتاد أن يكشف عن الجنسين وهم عرايا. وقد يبالغون في ذلك، خصوصاً بالنسبة للإماء، فيوضعن في طسوت ملأى بالماء، ثم يخرجن، فإن نقصت كمية الماء دل ذلك على الصحة
"وكان يوجد بين الجراكسة عائلات بتمامها، ذكوراً وإناثاً، كباراً وصغاراً؛ وقد اقتنى أبي عائلة مؤلفة من رجل وامرأة، وولد وبنت صغيرين
"وكان مالكو الرقيق يستمتعون بالإناث منه (الجواري) وخصوصاً البيض منهن. وكن يملأن بيوت الكبراء. وبذا اختلط الدم المصري بدم الجراكسة في بعض الأسر. وكان المصريون يعاملون الرقيق معاملة حسنة، فيرسلون الذكور للمدارس ويعتقونهم. ومن هؤلاء من وصل إلى وظائف مهمة في الجيش والإدارة، حتى إن شوارع حلوان قد سمي أكثرها بأسمائهم؛ ومنهم من كان يزوج بناته منهم، أما الإناث فكان يعنى بتزويج الكثيرات منهن"[1]
 ولما تولى الخديو إسماعيل حكم مصر أصدر أمراً إلى حكمدار السودان عام 1863 بتعقب تجار الرقيق ومنعهم بالقوة من ممارسة تجارتهم المحرمة، ونفذ الحكمدار أوامر الخديو فضبط 70 سفينة مشحونة بالرقيق واعتقل التجار الذين جلبوهم، أما الأرقاء فقد أطلق سراحهم وأعادهم إلى بلادهم. وفي عام 1865 احتل الجيش المصري بلدة فاشودة لكي يسد الطريق على تجار الرقيق، وأقام فيها نقطة حربية دائمة لمنع تجارة الرقيق. وفي 4 أغسطس عام 1877، وقعت مصر على معاهدة حظر الاتجار في الرقيق، مع فترة سماح لمن لديه جوارٍ لمدة 12 سنة للتصرف فيهن[2]
ولما تولى الخديو إسماعيل حكم مصر أصدر أمراً إلى حكمدار السودان عام 1863 بتعقب تجار الرقيق ومنعهم بالقوة من ممارسة تجارتهم المحرمة، ونفذ الحكمدار أوامر الخديو فضبط 70 سفينة مشحونة بالرقيق واعتقل التجار الذين جلبوهم، أما الأرقاء فقد أطلق سراحهم وأعادهم إلى بلادهم. وفي عام 1865 احتل الجيش المصري بلدة فاشودة لكي يسد الطريق على تجار الرقيق، وأقام فيها نقطة حربية دائمة لمنع تجارة الرقيق. وفي 4 أغسطس عام 1877، وقعت مصر على معاهدة حظر الاتجار في الرقيق، مع فترة سماح لمن لديه جوارٍ لمدة 12 سنة للتصرف فيهن[2]
استمرت عمليات تجارة الرقيق في مصر، على رغم صدور المعاهدة الثانية لمنع الرقيق في بروكسل عام 1890، وإنشاء مصلحة لرعاية شؤون الرقيق وبحث أحوالهن وما استتبع تطبيق قانون إلغاء الرقيق من إجراءات ومشكلات، يقودها ضابط إنجليزي يُدعى شيفر بك. وكانت من مهام المصلحة ملاحقة تجار الرقيق وتقديمهم للعدالة وكانت تلك الجريمة عقوبتها حينئذ السجن لمدة خمس سنوات. ووفق التقديرات البرطانية وتعداد السكان عام 1850 ومن واقع سجلات مكتب تجارة الرقيق الذي تأسس في أعقاب معاهدة عام 1877، فإن عدد الرقيق في مصر طوال القرن التاسع عشر تراوح بين 20 ألفاً و30 ألفاً[3]. وعلى رغم صعوبة تحديد رقم الرقيق في مصر آنذاك، فإن الباحثة جوديث تاكر، تقول إنه خلال الفترة بين عامي 1877 و1905، نال 25 ألفاً من الرقيق حريتهم في مصر[4]. غالبية هؤلاء الرقيق كن من النساء، اللاتي عملن خادمات في المنازل، كما وردت الوثائق حالات رق لغرض الزراعة في الصعيد، في حين جرى تجنيد أعداد كبيرة من الرقيق في الجيش مطلع القرن التاسع عشر[5]
لكن حادثة وقعت في عهد الخديو عباس حلمي الثاني حفيد إسماعيل، كان لها تأثير كبير على تاريخ الرق في مصر.
ففي الأول من أغسطس عام 1894 حطت في عزبة نصار بجوار أهرامات الجيزة قافلة مكونة من خمسة نخاسين من البدو معهم ست من الجواري، كالآتي:حمدان ومعه جارية تُدعى مريم، علي مبروك ومعه سعيدة، محمد شغلوب ومعه حليمة وفاطمة، محمد درحان ومعه مراسيلة، وعبد الله سعيد ومعه زنوبة
توجه النخاسون الخمسة إلى منزل أحد معارفهم بالعزبة - ويُدعى عبد الرحمن نصار- لإخفاء الجواري الست في حجرة بأعلى المنزل، لحين العثور على زبون. لجأ علي مبروك إلى صديق يهودي يدعى إبراهيم منير - وكان صاحب ورشة لإصلاح العربات سابقاً، قبل أن يصبح عاطلاً عن العمل في أغلب الأحيان- وباح له بالسر، وطلب منه أمرين، الأول هو البحث عن مشترٍ، والثاني هو تدبير وسيلة لنقل الجواري سراً إليه
صحبه إبراهيم منير إلى يوسف اليَسَرجي صاحب عربخانة بدرب المناصرة، فهو بحكم عمله يلتقي الأعيان، الذين يصلح لهم عرباتهم. أجابهم الرجل بأنه يعرف بستانياً في قصر علي باشا شريف رئيس مجلس شورى القوانين حينئذ
وبالفعل عرض البستاني الأمر على الباشا، فوافق وطلب عرض الجواري عليه بقصد المعاينة. عاد البستاني لإبلاغ أفراد المجموعة الذين كانوا في انتظاره في "قهوة أبو فراخ" في الفوالة
 وعلي باشا شريف هذا كان رجلاً قصير القامة، ممتلىء الجسم، يميل إلى الإسراف والتبذير. تزوج أربع نساء، بينهن مغنية سيئة السيرة، وعرف بطيشه ونزواته حتى إنه تم الحجر عليه مرتين وبلغت ديونه أكثر من 300 الف جنيه على الرغم من امتلاكه 13 ألف فدان
وعلي باشا شريف هذا كان رجلاً قصير القامة، ممتلىء الجسم، يميل إلى الإسراف والتبذير. تزوج أربع نساء، بينهن مغنية سيئة السيرة، وعرف بطيشه ونزواته حتى إنه تم الحجر عليه مرتين وبلغت ديونه أكثر من 300 الف جنيه على الرغم من امتلاكه 13 ألف فدانوعندما توفي عباس باشا الأول ورث ولده إلهامي باشا ثروته من الخيول العربية، لكنه انصرف عنها وباع حوالي 200 رأس من صفوة الخيل، اشترى أكثرها علي باشا شريف، فاستمر في تربيتها وأسس اسطبلات في الشارع الذي يعرف بالهدارة الذي يؤدي إلى شارع عبد العزيز في القاهرة. واشتهر علي باشا شريف بتنظيم حفلات سباق الخيل والعناية بها وإحراز قصب السبق في اقتناء خير الجياد، حتى صار عنده نحو 400 رأس، لكن مرض الطاعون حصدها. وبعد وفاته، بيعت خيول علي باشا شريف في مزاد عام
تولى هذا الباشا رئاسة مجلس شورى القوانين (7 سبتمبر 1884 - 24 سبتمبر 1894)، وكان هذا المجلس صنيعة الاحتلال وتألف من 30 عضواً يعين الإنجليز نصفهم، فضلاً عن كونه مجلساً استشارياً فقط، ليس قراراته ملزمة
في هذه الأثناء، كان شيء آخر يدور في عزبة نصار.فقد ارتاب مرشد يُدعى محمد بطران في التجار الخمسة، فجمع أتباعه وهجم على منزل عبد الرحمن نصار، وهو الرجل الذي أخفيت عنده الجواري وعثر عليهن بالفعل، لكنه أخذ بعض المصوغات وجنيهين من عبد الرحمن مقابل عدم إفشاء سره، فخرج وقال لأتباعه إنه لم يجد شيئاً
طلب الجميع التعجيل ببيع الجواري بعد هذا الموقف، وبالفعل حضر السمسار اليهودي ومعه زوجته تحت جنح الليل لنقل الجواري، كما كان معهم أحد خدم الباشا لإرشادهم إلى طريق القصر
عاين الباشا البضاعة وبعد مساومة دفع في ثلاث منهن - هن حليمة وسعيدة ومراسيلة- 60 جنيهاً، إضافة إلى 7 جنيهات للسماسرة، ثم استبدل الجارية سعيدة بزميلتها فاطمة، بعد أن رأى أن الأولى معتلة الصحة
ورجا النخاسون علي باشا شريف إخفاء الجواري الثلاث الباقيات في قصره لحين توفر مشترٍ، وهو ما تم بالفعل في اليوم التالي
الدكتور عبد الحميد الشافعي، طبيب مرموق، تعلم في أوروبا وتزوج أيضاً من طبيبة أوروبية شهيرة، أقامت معه في مصر بعد ذلك وعملت طبيبة لسيدات الأسر الكبيرة في مصر. استعرضت السيدة الجواري الثلاث، واشترت منهن واحدة، وطلبت إبقاء اثنتين لعرضهما على بعض معارفها. توجهت الطبيبة بهاتين الجاريتين إلى منزل حسين باشا واصف مدير مديرية أسيوط، وكانت حرم د. الشافعي طبيبة خاصة لزوجة حسين باشا واصف، وعرضت عليها الجاريتين، فاشترت واحدة، وأرسلت الأخيرة إلى عزبة محمد باشا الشواربي عضو مجلس النواب وأحد أعيان قليوب
كان مجلس شورى القوانين في تلك الفترة قد بدأ في المشاكسة والعناد، فرفض المرتبات الضخمة للموظفين الإنجليز ورأى أنها تستنزف ميزانية الدولة، كما أنهم بلا كفاءة تذكر تؤهلهم لتولي تلك المناصب. وانتقد المجلس شغل المناصب العليا في مصر بعددٍ من الأوروبيين، كما طالب بتفكيك مصلحة إلغاء الرقيق؛ لأنها تزدحم بالأوروبيين الذين يتقاضون مرتبات ضخمة، بالإضافة إلى أن تجارة الرقيق قد انتهت من مصر

وكان الخديو عباس حلمي الثاني، الشاب الصغير المعروف بمشاكسته لقوى الاحتلال، قد زار بعض وحدات الجيش المصري وانتقد بشدة مستوى التدريب السيء بها، مما عده السردار الإنجليزي كتشنر باشا قائد الجيش المصري حينئذ طعناً فيه وتقدم باستقالته، الأمر الذي أثار المعتمد البريطاني اللورد كرومر ضد الخديو، ودفعه إلى مطالبة الخديو باسترضاء كتشنر، وهو ما فعله خديو مصر مُكرهاً
في غضون ذلك، ظهرت علامات الثراء على محمد بطران، فشك فيه زملاؤه وأبلغوا عنه شيفر بك، وبعد البحث تبين صحة الشكوك، وتجمعت الخيوط في يد شيفر، وعرف من هم الزبائن، فانطلق إلى رؤسائه يبشرهم بالصيد الثمين
فقد خولف القانون، وممن؟ من رئيس مجلس شورى القوانين وعضوين في المجلس وطبيب مشهور. لقد بدت الفرصة سانحة للطم الجميع وإسكات الأصوات المشاغبة، والانتقام من المحرضين على رفض سياسات الاحتلال
توجه ضابط مصلحة الرقيق بنقطة الأهرام، إلى حيث يقيم النخاسون الخمسة وألقى القبض على أربعة منهم، في حين لاذ الخامس بالفرار. واعترف النخاسون تفصيلياً ببيع الجاريات إلى الباشوات المصريين. ووصلت إشارة إلى مأمور قسم السيدة زينب، وهو البكباشي محمد ماهر، فتوجه إلى منزل الدكتور الشافعي وسأله عن الموضوع، فأجاب الطبيب بمنتهى البراءة بكل تفاصيل الموضوع[6]
أرسل علي باشا شريف وحسين واصف باشا والدكتور الشافعي إلى قسم عابدين ليبيتوا فيه، على ذمة التحقيق في القضية. أما الشواربي باشا، فإن الجنود الذين ذهبوا لإلقاء القبض عليه لم يجدوه في منزله بالقاهرة، وقيل لهم إنه موجود في عزبته في قليوب، فأرسلت إشارة عاجلة لضبطه وإحضاره مخفوراً إلى القاهرة
وتوجه الضابط محمد ماهر إلى بيت رئيس مجلس شورى القوانين علي باشا شريف، وطلب التحقيق معه، لكن الباشا تذرع بحصانته البرلمانية ورفض التحقيق. ورفع محمد ماهر تقريراً بذلك إلى رئيسه الإنجليزي شيفر بك، فتقرر استدعاء علي باشا شريف للتحقيق، فتوجه الباشا إلى وكيل نظارة الداخلية الذي أفاده بأنه لا علاقة له بالموضوع وأنه مطلوب للتحقيق في مكتب شيفر بك
توجه علي باشا شريف إلى مكتب شيفر وهم بالدخول، فمنعه الحاجب وجعله ينتظر فترة قبل أن يسمح له بالدخول.وجه الضابط شيفر بك إلى علي باشا شريف تهمة الاشتراك في الاتجار بالرقيق، فطلب الباشا الاتصال برئيس النظار نوبار باشا أو الإبراق له، لكن الضابط الإنجليزي رفض. وعندئذ لجأ الباشا إلى حيلة كان يلجأ إليها أثرياء مصر في ذلك العهد، وهي الاحتماء بسفارة أجنبية بحجة أنه واحد من رعاياها، حتى يتمتع بالامتيازات الأجنبية التي لم تكن قد ألغيت بعد. فقد زار علي باشا شريف أحد أبنائه فطلب منه ضرورة إحضار ورقة مهمة من بيته تفيد بأنه يتمتع بالجنسية الإيطالية، وبالفعل عثر عليها ابنه وعرضها على القنصل الإيطالي الذي توجه معه إلى القسم وطلب الإفراج عن الباشا لكونه أحد رعايا إيطاليا، وهو ما تم على الفور
أما واصف باشا والدكتور الشافعي، فقد أفرج عنهما بضمانة من عثمان باشا ماهر
كان كبار المسؤولين حينها يُصيفون خارج القطر المصري، فالخديو عباس كان مسافرا للآستانة ومنها إلى فينيسيا وسويسرا، أما اللورد كرومر فكان يروِّح عن نفسه بالصيد والقنص في مروج اسكتلندا. في هذه الأثناء، كان نوبار باشا رئيس النظار ونائب الخديو يمارس سلطته من قصره بالإسكندرية، ووصلت إليه أخبار الحادث لكنه آثر الانتظار حتى يرجع الخديو، فمازالت حادثة السير كتشنر قريبة، وبدا له أن الموضوع له أبعاد أخرى، فمن غير الطبيعي أن يتخذ شيفر بك إجراءات بمثل هذه الخطورة بدون موافقة ودعم رؤسائه
 وتحت الضغط الشديد على نوبار باشا، وافق على إحالة القضية إلى المحاكمة العسكرية. وصدر قرار من السردار كتشنر باشا بتشكيل المجلس العسكري العالي برئاسة ضابط أرمني يُدعى زهراب باشا، وعضوية عدد آخر من الضباط الإنجليز والمصريين
وتحت الضغط الشديد على نوبار باشا، وافق على إحالة القضية إلى المحاكمة العسكرية. وصدر قرار من السردار كتشنر باشا بتشكيل المجلس العسكري العالي برئاسة ضابط أرمني يُدعى زهراب باشا، وعضوية عدد آخر من الضباط الإنجليز والمصريينتوجه الشعب – الذي أثاره موقف الاحتلال من مسؤولين مصريين- بنظره إلى الخديو أملاً في إنقاذ الموقف، وكان ينظر للحاكم على أنه سيدٌ مطلق، حتى إن أمير الشعراء أحمد شوقي نظم قصيدة في نهاية عام 1900 في مدح الخديو عباس يهنئه على حلول شهر رمضان المعظم كان مطلعها:
عباس ظل الله في مصر ------------- ومجمل الاسلام في العصر[7]
أمر عباس حلمي الثاني بتأجيل القضية لحين عودته، لكن هذا التأجيل لم يستمر سوى يوم واحد، فالجميع في النهاية خضع لسلطان الاحتلال
تشكلت محكمة عسكرية في 4 سبتمبر 1894 لمحاكمة كل من اشترك في الجريمة: النخاسين والجواري والباشوات. استقطبت المحاكمة اهتمام جميع الأطراف، ومن هؤلاء الزعيم الوطني مصطفى كامل الذي انتقد بسرعة إجراءات تلك المحاكمة ، فيما أرسلت الصحف المصرية مجموعة من مراسليها إلى قاعة المحكمة لموافاتها بتقرير إخباري يومي عن تطورات المحاكمة. كما أرسلت "لندن تايمز" و"ذي مانشستر غارديان" صحفيين للتغطية الغخبارية، وكذلك فعلت الصحف الإيطالية والفرنسية. وبدت محاكمة الباشوات، كما أصبحت معروفة، فضيحة ذات أبعاد دولية
أخذت المحاكمة شكل المواجهة بين معسكرين
على جانب واحد برز معسكر المدافعين عن الرقيق وهم موالون للنخبة من المشترين، إضافة إلى محامي الدفاع وغيرهم من الوطنيين الذين يعتقدون أنه لا توجد جريمة في شراء الرقيق والجواري من السودان. وأصر هؤلاء الكتاب الوطنيون على أن جلب الرقيق والجواري من السودان ليس في حقيقة الأمر سوى مهمة حضارية لتعليم هؤلاء الفتيات السودانيات الفنون الراقية وشؤون التدبير المنزلي وتعاليم الإسلام بطريقة لا يمكن أن يحصلن عليها في السودان نفسه
على الجانب الآخر وقف المسؤولون البريطانيون ودعاة إلغاء الرق، الذين رأوا في شراء الجواري مثالاً آخر على الوحشية والاستبداد، مما يثبت عدم قدرة المصريين من أن تكون قادرة على حكم بلادهم، وفي ذلك تبرير آخر لاستمرار الوجود البريطاني في مصر
في قفص الاتهام، وقف حسين باشا واصف والشواربي باشا والدكتور الشافعي، بجوار النخاسين الأربعة المقبوض عليهم والمرشد الخائن والسمسار اليهودي وصاحب العربخانة، في حين كان علي باشا شريف قد سقط قبل ذلك بأيام متأثراً بأزمة قلبية حادة، وأُجِّلت محاكمته إلى حين شفائه
أرسلت المحكمة إلى القنصلية الإيطالية لتسألها هل علي باشا شريف يتمتع بحمايتها أم لا؟ فردت القنصلية الإيطالية بأن الباشا وإن كان قد قيد نفسه بدفاترها كرعية إيطالية إلا أنه لم يدفع الاشتراكات المفروضة على الرعايا الإيطاليين منذ عدة سنين، وعليه فهو لا يعتبر واحداً من رعاياها[8]
دفاع المتهمين من الباشوات انحصر في نقطة قانونية، هي أن الإثم هو الاتجار في الرقيق فقط، أما الشراء فلا يعاقب عليه القانون، وأن الاتهام ينحصر في النخاس فقط وليس بالنسبة للمشترين؛ لأن المشتري يقدم خدمة للجارية، إذ تنتقل من حياةٍ قاسية تعاني شظف العيش إلى رغده[9]
وكان القانون ينص بالفعل على عقاب التاجر لكنه لم ينص على عقاب المشتري، وهو ما فطنت إليه الداخلية، فأصدرت منشوراً يفيد بأن العقوبة للبائع والمشتري باعتبار أن كلاً منهما مكمل للآخر
وأقبلت الجواري للشهادة، فقالت سعيدة: "سيدي اللي في سيوة مات، وأهل بيته باعوني لسيدي على مبروك (النخاس) وجينا من سيوة لمصر"
أمر القاضي زنوبة بأن ترفع رأسها عندما تتكلم، فكانت ترفعه لثوان ثم يهبط مرة أخرى، فالرأس اعتاد الانحناء، وبعد تكرار الطلب من القاضي، أصابه اليأس وسلم أمره لله وكف عن أن يأمرها برفع رأسها
ثم طلب القاضي من مريم أن تصف المكان الذي أتى بها النخاسون إليه، فأجابت قائلة: "جنب الحجرين الكبار والحجر الصغير" تقصد أهرام الجيزة، فضجت القاعة بالضحك.سألها القاضي: هل تعرفين الشواربي باشا، فأجابت بنعم، وعندما سألها: هل له لحية؟، لم تستطع الإجابة فهي لا تعرفها.فقال لها القاضي: اللحية شعر ينبت في الوجه، في حين أشار أحد الأعضاء إلى لحيته
فجأة أصبحت الجواري الخمس حديث الساعة ومحل اهتمام العالم كله، يهتم لأمرهن الخديو وكرومر، ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا، تتبنى قضيتهن جريدة "التايمز" وكبرى صحف العالم
اتهمت صحف عالمية المصريين بالتوحش والبربرية، فيما تغزلت "التايمز" في العدالة الإنجليزية التي تلقن الشعوب الهمجية دروساً في الحرية والمساواة
وفي إيطاليا، أمر وزير الخارجية بنقل القنصل الإيطالي في مصر؛ لأنه تدخل للإفراج عن علي باشا شريف، وطلب تأجيل محاكمته دون أن يستأذن من الحكومة الإيطالية أولاً. كما أمرت الخارجية الإيطالية بنفي الفرنسي - الإيطالي، "المسيو جوارنبري" – صاحب ومدير جريدة "الجورنال إجبسيان" التي تصدر في مصر- لأنه هاجم إنجلترا
ودارت رحى المعركة نفسها بين الصحف المصرية، فتبنت جريدة "المقطم" - وكانت ممالئة للاحتلال- قضية الجواري والحرية والكرامة، وهاجمت الباشوات "الذين يتمنون أن يكونوا هم السادة وسائر الناس العبيد".دافعت الجريدة دفاعاً مستميتاً عن حرية الإنسان وضرورة تحرير العبيد، وأوضحت موقف الإسلام تجاهه، وأن البيع والشراء وجهان لعملة واحدة. واستماتت تلك الصحيفة وغيرها من صحف الاحتلال في الدفاع عن العبيد والمطالبة بتحريرهم، والمطالبة بسيادة القانون وتساوي الجميع أمامه
 وكتب محرر "الإجبشيان جازيت"، التي تحظى بدعم اللورد كرومر، مقالاً خلال سير المحاكمة قال فيه إن العلاقة بين المالك والرقيق وثيقة الصلة بالسؤال الأكبر، وهو: أي الثقافتين أو الحضارتين، البريطانية أم المصرية، أفضل وأكثر استعداداً للسيطرة على السودان نفسه؟
وكتب محرر "الإجبشيان جازيت"، التي تحظى بدعم اللورد كرومر، مقالاً خلال سير المحاكمة قال فيه إن العلاقة بين المالك والرقيق وثيقة الصلة بالسؤال الأكبر، وهو: أي الثقافتين أو الحضارتين، البريطانية أم المصرية، أفضل وأكثر استعداداً للسيطرة على السودان نفسه؟بالنسبة لمحرر الجريدة، فقد كان المجتمع المصري متأثراً إلى حد بعيد بقدر من الاستبداد الإسلامي بشكل علني أو في الخفاء، وهو عامل يجعل في رأيه المصريين غير قادرين على حكم الآخرين![10]
وبدا لكثيرين أننا أمام مفارقة مضحكة، إذ إن تلك الصحف تحديداً لم تأل جهداً للدفاع عن شرعية الاحتلال، في حين تجاهلت عدالة قضية الاستقلال الوطني
أما إبراهيم رمزي الأرضروملي، صاحب جريدة "الفيوم"، وهو أيضاً كاتب وشاعر شهير، فقد كان من القلائل الذين حملوا على النخاسين والباشوات على حد سواء، واتهمهم بالوحشية والبربرية. وقال في مقال له إن هؤلاء الباشوات الأعضاء في مجلس شورى القوانين كان يُفترض بهم أن يكونوا أشد الناس حرصاً على قيم ومبادىء الأمة، فإذا فسدوا فإن المجتمع كله سيصاب بالفساد[11]
على الجانب الآخر، تبنت الصحف المصرية الوطنية المعارضة للاحتلال مهمة الدفاع عن الباشوات وتبرير قضية الرق
فعلى سبيل المثال، رأت جريدة "المؤيد"، لصاحبها الشيخ علي يوسف، أن الحادثة مدبرة بهدف البرهنة على "عدم كفاءة رجال الشورى لمناصبهم"، وقالت أيضاً إن اختيار علي باشا شريف بالذات لإيقاعه في هذا الفخ عملية مقصودة "بصفته رئيس مجلس كان في آخر السنة الماضية يعارض في بقاء "مصلحة إلغاء الرقيق" ويبرهن على قلة الحاجة إليها بزوال معنى الاسترقاق من عقول المصريين"[12]
وناقشت "المؤيد" قضية الحرية الشخصية للباشوات وإساءة استخدام السلطة معهم، ووصفت إجراءات شيفر بك بالمتعسفة. وقالت الصحف ذات الميول الوطنية إن شراء الرقيق عمل حضاري بعكس بيعه، فالسادة بذلك الفعل يقدمون عملاً للخير، فالرقيق لم يطمعوا في العتق ولا يرغبون في مفارقة منازل وقصور شبوا فيها ولم يعرفوا سواها، فالعبيد الذين غادروا منازل أسيادهم عانوا الفقر المدقع والتشرد، وأدى بهم هذا إلى "أن يعاشروا أمثالهم من أبناء جلدتهم، ففسدت أخلاقهم تمام الفساد.. واصبحوا ضربة قاضية على الحرية وعالة على الإنسانية، وقد بلغ الشقاء ببعضهم مبلغاً ليس بعده غاية، وهم أحرار، فليتهم لبثوا أرقاء، فإنه كان خيراً لهم في كل حال"[13]
كما شددت تلك الصحف على أنه من حق أي عبد أو جارية أن يطلب عتقه وقتما أراد ويمنح شهادة بذلك
ومن المؤسف حقاً أن يكون هذا هو دفاع الصحافة الوطنية التي كانت تحارب الاحتلال بشدة وتستنقذ كرامة الشعب
ردد الدفاع عن الشواربي باشا – وكان يتولاه خليل بك إبراهيم- الفكرة نفسها، فقال إن من يشتري عبداً أو جارية، فإنه ينقله من التعاسة إلى السعادة ويحسن تربيته ويطعمه ويكسوه ويشبعه، فينقذه بالتالي من أسباب الشقاء ووجوه الفقر[14]
أما الدفاع عن واصف باشا فقد احتج في مرافعته على قلم الرقيق؛ لأنه أخرج الجارية "سعيدة" من منزل الباشا ومنحها شهادة العتق، وقال: "بفرض المستحيل أنه اشتراها فإنه لا يحق للمذكور أن يعتقها طالما أنها لم تشتكِ أو تطلب عتقها"[15]
من جهته، غازل إسماعيل بك عاصم الاحتلال في مرافعته، وتحدث عن دوره في نقل مصر إلى المدنية، وأثنى على دور مصلحة الرقيق، وقال "ولكن نقول إن عمال قلم الرقيق مجتهدون.. والمجتهد لا يكون معصوماً، بل هو دائماً مُعرضٌ لكل خطأ"
وفي محاولة لتبرئة أنفسهم، ادعى النخاسون أن الجواري الست لسن سوى زوجات لهن
وبالنسبة لرجال مثل فريث بك، وهو أحد القضاة الإنجليز في المحاكمة، فإنه يمكن فقط وصف الجواري بأنهن ضحايا: فريسة بريئة، وجاهلة للصوص الرقيق الذين يشنون غارات بهدف أسرهن، والنخب المسلمة التي بلا ضمير[16]
وخلال المحاكمة، اقتراح السردار كتشنر باشا تفتيش حريم علي باشا شريف بحثاً عن ثلاث من الجواري. وفي أثناء البحث "كان يتم التعرف على النساء البيضاوات عبر أيديهن، ويسمح لهن بالمرور بدون فحصهن"[17]. في نظر هؤلاء المسؤولين، إذن، ارتبطت فكرة الرقيق باللون. وأي امرأة ذات بشرة سوداء تعيش في كنف أسرة مصرية، فإنها تعتبر تلقائياً من الرقيق. ورأت بريطانيا أن وجود النساء غير المتزوجات من ذوات البشرة السوداء في شوارع القاهرة، مؤشراً يدعو إلى القلق
وبحسب وثائق وزارة الخارجية البريطانية، فقد أبدى مسؤولون في الخارجية خشيتهم من أنه، بمجرد التحرر من العبودية، فإن النساء السودانيات من ذوات المهارات القليلة والصلات العائلية المحدودة، يعدن إلى الأسر المسلمة، ليصبحن فريسة مرة أخرى إما للرق أوالتسري أو البغاء. ولمواجهة ذلك، تأسست "دار الجواري المعتقات" في القاهرة عام 1886 للمساعدة في توفير عمل مناسب لهؤلاء المساء، وأغلبهن من السودان وإثيوبيا[18]
من جهته، كان البوليس المصري في منتصف القرن التاسع عشر إذا ألقى القبض على امرأة ذات بشرة سوداء ولم تتمكن من تقديم ما يثبت أنها حرة وليست من الرقيق، فإنه كان يعيدها إلى سوق الرقيق في حي خان الخليلي[19]
إلا أنه مع إغلاق مثل تلك الأسواق، وتشديد الحرب على الرق، لجأ البعض إلى التمييز بين الجواري وغيرهن عن طريق الملبس. وفي أثناء إدلاء الشهود بإفاداتهم عن حركة الجواري وتنقلهن من وإلى منازل الباشوات، كانت الملابس هي التي تحدد هوية الجارية[20]. وعلى سبيل المثال، فإنه في أثناء المحاكمة، سأل محامي الدفاع سائق العربة عن لون الملابس التي رآها على إحدى الجواري وهي تغادر منزل علي باشا شريف، وهل كانت تلك الملابس معروفة أم لا بوصفها ملابس مصرية؟[21] وسأل محام آخر البواب كيف عرف أن المرأة التي تم جلبها إلى المنزل الذي يحرسه من الجواري، فرد بالقول "من ملابسها". وأضاف وفق ما أوردته الصحف أنها "جاءت بملاءة سوداء وغطاء وجه أبيض، كملابس الجارية"[22]
استغرقت "محاكمة الباشوات" نحو عشرة أيام
ولما كانت الإدارة الإنجليزية قد شفت غليلها وأسكتت الساسة في مصر وقرصت آذان البعض، فقد صدر الحكم في 13 سبتمبر كالتالي:
براءة حسين باشا واصف ومحمد باشا الشواربي، أما الدكتور عبد الحميد الشافعي فقد أدين وصدر حكمٌ بحبسه خمسة شهور، كما صدرت أحكام على النخاسين وصلت إلى السجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة
اندهش كثيرون لهذا الحكم، الذي استند إلى أن الدكتور الشافعي هو من اعترف صراحة بشراء جارية، في حين أنكر الشواربي باشا الأمر، وأصر حسين باشا واصف على أن حرم الطبيب هي من أرسلت الجارية لتتعلم الطبخ في مطابخه
واتهمت جريدة "الأهرام" الطبيب الشافعي بأنه دسيسة إنجليزية، وقالت إنه اعترف ليورط الباشوات الثلاثة في القضية
وسخر الأدباء والشعراء من الحكم، فقال أحدهم مخاطباً الدكتور الشافعي:
ونظم إبراهيم رمزي في مديح المجلس العسكري شعراً جاء فيه:
دعوى الرقيق أبانت عدل من حكموا ---------- فيا بني مصر، أنتم خير أقبال
فبائع الناس ذو إثم بفعلته --------------- لكن شاريهم خلٌ لهم غال
بعد ذلك، لم يجرؤ مجلس شورى القوانين على أن يثير مرة أخرى موضوع إقفال أو تفكيك مصلحة إلغاء الرقيق[24].أما الجواري فقد خرجن من قاعة المحكمة إلى الحرية، ومنحتهن مصلحة إلغاء الرقيق مستندات تثبت عتقهن من الرق، وأقمن لفترة معاً في دار الجواري المعتقات في القاهرة، بدعم من الجمعية البريطانية والأجنبية لمكافحة الرق[25]. وحين غادرن المنزل إما للعمل في مصرأو للزواج اختفت أخبارهن فلم يُعرف أين ذهبن، وإن كان الثابت أن مريم، أكثرهن ذكاء، كانت أول من مزق شهادة العتق الصادرة عن المصلحة البريطانية، وعادت إلى بيت سيدها[26]
وأيامها، لم يكن هناك أمام الجواري من سبيل للحياة المستقرة سوى أن يعملن في منازل وقصور تضمن لهن المسكن والطعام.. والأمان!
[1] أحمد شفيق، مذكراتي في نصف قرن جـ 1 (1873- 8 يناير 1892)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999
[2] إقبال بركة، حكاية الباشوات والجواري، جريدة "الأهرام"، القاهرة، 7 مارس 2001
[3] Gabriel Baer, “Slavery and Its Abolition” in Studies in the Social History of Modern Egypt, Chicago: University of Chicago Press, 1969, p. 167
[4] Judith E. Tucker, Women in nineteenth-century Egypt, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1985
[5] See: Tucker, p. 167; Baer, p. 165; John O. Hunwick, “Black Africans in the Mediterranean” in Slavery and Abolition, 13:1, April 1992, p. 21
[6] صلاح عيسى، حكايات من دفتر الوطن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، ص 233
[7] أحمد شوقي، الشوقيات، دار الأرقم للطباعة والنشر، عمان، 2001
[8] إقبال بركة، حكاية الباشوات والجواري، مرجع سابق
[9] عبد الحميد يونس، تاريخنا الجنائي في الشارع السياسي، مرجع سابق، 2003
[10] The Egyptian Gazette, Cairo, 31 August 1894
[11] جريدة "الفيوم"، الفيوم، 6 سبتمبر 1894
[12] صلاح عيسى، مرجع سابق، ص 241
[13] المرجع السابق، ص 242
[14] جريدة "المقطم"، القاهرة، 10 سبتمبر 1894
[15] صلاح عيسى، مرجع سابق، ص 244
[16] Eve Troutt Powell,The Tools of the Master: Slavery and Empire in Nineteenth Century Egypt, School of Social Science, Institute for Advanced Study, New Jersey, 1 September 2002, Paper Number 13
[17] F.O. 407/127 Rodd to Kimberly, 17 September, 1894
[18] F.O. 84/1770 Report by C.G. Scott Moncrieff, May 1886
[19] Terence Walz, “Black Slavery in Egypt”, Slaves and Slavery in Muslim Africa, vol. 2, ed., John Ralph Willis (London: Frank Cass, 1985), p. 149
[20] Ibid., p. 139
[21] جريدة "المقطم"، القاهرة، 6 سبتمبر 1894
[22] جريدة "المقطم"، القاهرة، 10 سبتنمبر 1894
[23] F.O. 407/127, no. 125 and 126 Rodd to Kimberly, Cairo, Sept. 24, 1894
[24] .Eve Troutt Powell,The Tools of the Master: Slavery and Empire in Nineteenth Century Egypt
[25] The Anti-Slavery Reporter, vol. 14 (July-August 1894), p. 246
[26] صلاح عيسى، مرجع سابق، ص 250
















 وارتفعت أسعار حاجيات المعيشة الضرورية إلى درجة عالية، ووقع عبء هذا الارتفاع على كاهل الطبقات الفقيرة التي لم يكن باستطاعتها ولا بقدرتها دفع الأثمان العالية للوازم حياتها. وتبعاً لذلك، زادت الوفيات من 300 ألف حالة قبل الحرب إلى 375 ألف حالة عام 1916، وفي عام 1918 وصل عددها إلى 510 آلاف حالة أو أكثر من عدد المواليد في تلك السنة، هذا بالإضافة إلى ضحايا الحرب والجرحى والمشوهين
وارتفعت أسعار حاجيات المعيشة الضرورية إلى درجة عالية، ووقع عبء هذا الارتفاع على كاهل الطبقات الفقيرة التي لم يكن باستطاعتها ولا بقدرتها دفع الأثمان العالية للوازم حياتها. وتبعاً لذلك، زادت الوفيات من 300 ألف حالة قبل الحرب إلى 375 ألف حالة عام 1916، وفي عام 1918 وصل عددها إلى 510 آلاف حالة أو أكثر من عدد المواليد في تلك السنة، هذا بالإضافة إلى ضحايا الحرب والجرحى والمشوهين وبعد فترة من الارتباك والتردد، اضطرت الحكومة المصرية أثناء الحرب العالمية الأولى إلى منح موظفيها علاوات غلاء معيشة. الطريف أن الحكومة رأت في الوقت نفسه أن تستقطع من الموظف الذي يزيد مرتبه على 15 جنيهاً رُبع المرتب والذي يزيد مرتبه على 50 جنيهاً ثلث مرتبه، ثم قرر قومسيون بلدية الإسكندرية توفير المستخدمين الذين لايزيد مرتب الواحد منهم على 14 جنيهاً في الشهر، بحجة التدابير الاقتصادية. حدث ذلك في وقتٍ كان أكثر موظفي بلدية الإسكندرية يتقاضون فيه راتباً شهرياً يتراوح بين 40 جنيهاً و100 جنيه
وبعد فترة من الارتباك والتردد، اضطرت الحكومة المصرية أثناء الحرب العالمية الأولى إلى منح موظفيها علاوات غلاء معيشة. الطريف أن الحكومة رأت في الوقت نفسه أن تستقطع من الموظف الذي يزيد مرتبه على 15 جنيهاً رُبع المرتب والذي يزيد مرتبه على 50 جنيهاً ثلث مرتبه، ثم قرر قومسيون بلدية الإسكندرية توفير المستخدمين الذين لايزيد مرتب الواحد منهم على 14 جنيهاً في الشهر، بحجة التدابير الاقتصادية. حدث ذلك في وقتٍ كان أكثر موظفي بلدية الإسكندرية يتقاضون فيه راتباً شهرياً يتراوح بين 40 جنيهاً و100 جنيه وبدا واضحاً أن سنوات الحرب العالمية الأولى كان عنوانها كثرة جرائم القتل والحوادث الجنائية، مع انتشار سلطة الأشقياء والخطرين. وقويت شوكة عصابات السرقة، حتى كان أفراد هذه العصابات يسرقون الحبوب من مخازنها فوق الأسطح ويسرقون المصوغات والنقود، وانضم إليهم بعض الخفراء. ولما كثرت الجنايات وتعددت حوادث السطو، اضطرت وزارة الداخلية إلى نشر بلاغ رسمي أمرت فيه المشايخ والعُمد أن يقدموا إلى مأموري المراكز تقارير وافية كاملة يذكرون فيها أسماء الرجال المشتبه فيهم في دائرة محيطهم، وفي نفس الوقت يلاحظون عن قرب جميع التحركات
وبدا واضحاً أن سنوات الحرب العالمية الأولى كان عنوانها كثرة جرائم القتل والحوادث الجنائية، مع انتشار سلطة الأشقياء والخطرين. وقويت شوكة عصابات السرقة، حتى كان أفراد هذه العصابات يسرقون الحبوب من مخازنها فوق الأسطح ويسرقون المصوغات والنقود، وانضم إليهم بعض الخفراء. ولما كثرت الجنايات وتعددت حوادث السطو، اضطرت وزارة الداخلية إلى نشر بلاغ رسمي أمرت فيه المشايخ والعُمد أن يقدموا إلى مأموري المراكز تقارير وافية كاملة يذكرون فيها أسماء الرجال المشتبه فيهم في دائرة محيطهم، وفي نفس الوقت يلاحظون عن قرب جميع التحركات وفي ظل تلك الظروف، أطلت البطالة برأسها
وفي ظل تلك الظروف، أطلت البطالة برأسها والشاهد أن مصر بمدنها وريفها قد تأثرت بشدة بهذا الكساد العالمي، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، ومن ذلك أحوال المعيشة والزواج والطلاق والتعليم والصحة والتبشير والبطالة والإجرام والبغاء والمخدرات
والشاهد أن مصر بمدنها وريفها قد تأثرت بشدة بهذا الكساد العالمي، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، ومن ذلك أحوال المعيشة والزواج والطلاق والتعليم والصحة والتبشير والبطالة والإجرام والبغاء والمخدرات وتقدم د. عبير حسن عبدالباقي في دراسةٍ مهمة لها ملامح تستحق الرصد والتحليل عن طبيعة الجرائم التي ارتكبها أصحاب الياقات البيضاء، أو الأفندية، خلال النصف الأول من القرن العشرين
وتقدم د. عبير حسن عبدالباقي في دراسةٍ مهمة لها ملامح تستحق الرصد والتحليل عن طبيعة الجرائم التي ارتكبها أصحاب الياقات البيضاء، أو الأفندية، خلال النصف الأول من القرن العشرين وربما نلاحظ من الأرقام السابقة أن عدد جرائم الرشوة في القاهرة ارتفع ووصل إلى ذروته أثناء وقبل الأزمة المالية العالمية وأثناء الحرب العالمية الثانية. أمرٌ يشير بجلاء إلى ارتباط معدل جرائم التعدي على المال بدون إكراه – كالرشوة- في أوقات الأزمات الاقتصادية. بل إن انخفاض أرقام جرائم الرشوة أثناء الحرب العالمية الأولى قد يكون خادعاً، إذ يمكن أن نعزو ذلك إلى انشغال أجهزة الأمن بأمور أخرى، مثل الحفاظ على استقرار الأوضاع في البلاد وتقديم الخدمات المختلفة لقوات الجيوش المتحاربة على أرض مصر
وربما نلاحظ من الأرقام السابقة أن عدد جرائم الرشوة في القاهرة ارتفع ووصل إلى ذروته أثناء وقبل الأزمة المالية العالمية وأثناء الحرب العالمية الثانية. أمرٌ يشير بجلاء إلى ارتباط معدل جرائم التعدي على المال بدون إكراه – كالرشوة- في أوقات الأزمات الاقتصادية. بل إن انخفاض أرقام جرائم الرشوة أثناء الحرب العالمية الأولى قد يكون خادعاً، إذ يمكن أن نعزو ذلك إلى انشغال أجهزة الأمن بأمور أخرى، مثل الحفاظ على استقرار الأوضاع في البلاد وتقديم الخدمات المختلفة لقوات الجيوش المتحاربة على أرض مصر وفي عموم القطر المصري، يتضح لنا مجدداً أن الجرائم المسجلة خارج القاهرة كانت أكبر بكثير. فقد سجلت التقارير السنوية لوزارة الداخلية عن حالة الأمن العام 25 جريمة اختلاس عام 1929، و24 جريمة في عام 1930، قبل أن يرتفع الرقم إلى 39 في عام 1931. وعام 1933 بلغ الرقم 24 جريمة اختلاس مسجلة، قبل أن ينخفض الرقم إلى 19 حالة في كلٍ من عامي 1934 و1935، و21 جريمة في عام 1936. وإذا كان عام 1937 قد شهد ضبط 11 جريمة اختلاس، فإن عام 1950 شهد تسجيل 15 جريمة من هذا النوع
وفي عموم القطر المصري، يتضح لنا مجدداً أن الجرائم المسجلة خارج القاهرة كانت أكبر بكثير. فقد سجلت التقارير السنوية لوزارة الداخلية عن حالة الأمن العام 25 جريمة اختلاس عام 1929، و24 جريمة في عام 1930، قبل أن يرتفع الرقم إلى 39 في عام 1931. وعام 1933 بلغ الرقم 24 جريمة اختلاس مسجلة، قبل أن ينخفض الرقم إلى 19 حالة في كلٍ من عامي 1934 و1935، و21 جريمة في عام 1936. وإذا كان عام 1937 قد شهد ضبط 11 جريمة اختلاس، فإن عام 1950 شهد تسجيل 15 جريمة من هذا النوع وانتشر الربا بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة، وظهر المرابون في القرى والعواصم والبنادر، فكبلوا المزارعين بالديون ووصل الأمر إلى فقدان الملكيات، فقد أراد تاجر أن يقترض 500 جنيه إلى سنة، فطلب 50%، واقترض صاحب محل 150 جنيهاً بفائدة قدرها 45% وقد أصبحت قيمة الجنيه المصري في شرع المرابين 480 قرشاً
وانتشر الربا بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة، وظهر المرابون في القرى والعواصم والبنادر، فكبلوا المزارعين بالديون ووصل الأمر إلى فقدان الملكيات، فقد أراد تاجر أن يقترض 500 جنيه إلى سنة، فطلب 50%، واقترض صاحب محل 150 جنيهاً بفائدة قدرها 45% وقد أصبحت قيمة الجنيه المصري في شرع المرابين 480 قرشاً أما جرائم الانتحار فقد كانت في الغالب الأعم نتيجة اضطرابات عصبية وضغوط نفسية، أو نتيجة إدمان المخدرات والمسكرات، والضيق المالي، وسوء المعاملة، والتخلص من مرض ما
أما جرائم الانتحار فقد كانت في الغالب الأعم نتيجة اضطرابات عصبية وضغوط نفسية، أو نتيجة إدمان المخدرات والمسكرات، والضيق المالي، وسوء المعاملة، والتخلص من مرض ما